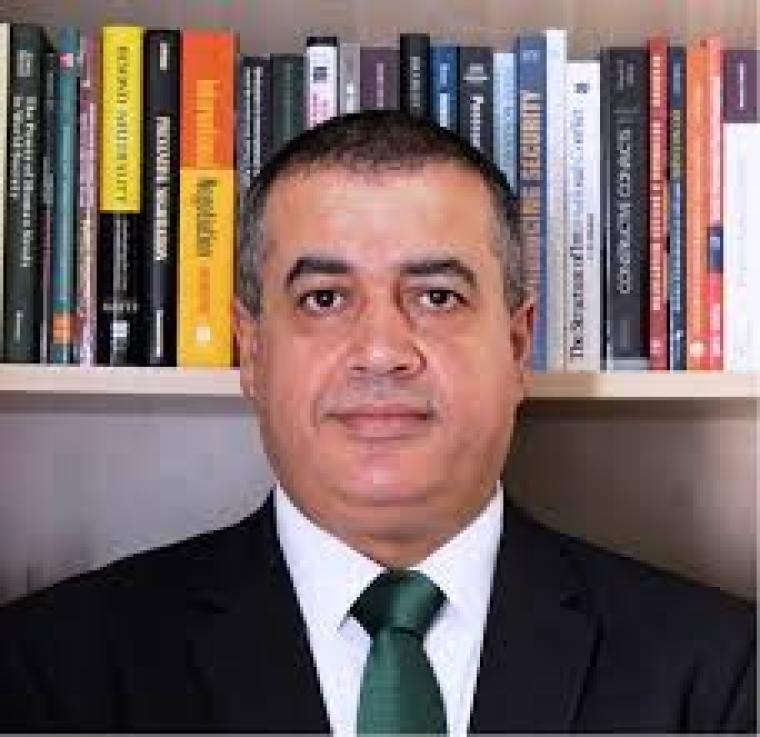هل ما زالت فلسطين قضية العرب المركزية؟/ بقلم: د. إبراهيم فريحات
فلسطين اليوم
(أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا)
منذ صدور وعد بلفور 1917 وحتى انطلاق ثورات الربيع العربي حافظت القضية الفلسطينية على موقع متقدم في قائمة الأولويات العربية إن لم تكن على رأسها، ولكن ليس دوماً. ففي محطات عربية مفصلية تراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية لحساب القضايا الوطنية (مثل الحرب العراقية – الإيرانية والاحتلال العراقي للكويت) ولكن ما لبث أن عاود اعتبار فلسطين أولوية أو بلغة أخرى قضيته «المركزية». يكاد يجمع المراقبون على أن القضية الفلسطينية لم تأخذ الاهتمام العربي الأول في فترة الربيع العربي، والتي طالت هذه المرة، ومرة أخرى تطفو القضايا الوطنية على حساب القضايا القومية برمتها وليس فقط القضية الفلسطينية. وهذا يدعونا للتساؤل فيما إذا كانت القضية الفلسطينية ستعاود القفز إلى رأس سلم الأولويات العربية بعد انتهاء أزمة الربيع العربي الراهنة أم أن تراجع الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية قد أصبح دائماً ولا عودة للماضي، وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يمكن للفلسطينيين تطوير استراتيجية جديدة لإدارة علاقاتهم مع «عمقهم الاستراتيجي» أي العالم العربي في ظل هذه التغيرات.
لنبدأ أولاً بجانب مفاهيمي حول المقصود بـ«مركزية» القضية الفلسطينية حيث يلاحظ استخدام المفهوم بمعاني مختلفة ويتم توظيفه أحياناً لخدمة سرديات مختلفة، منها من ينادي عربيا بالتخلي عن «مركزية» القضية الفلسطينية وهنا يوظف مفهوم «المركزية» بمعنى «الأولوية» و«الولاء » للقضية على حساب القضايا الوطنية لهذه الدول. فمركزية القضية الفلسطينية حسب هؤلاء تعني «خيانة» لقضاياهم الوطنية التي يجب أن تحتل الأولوية القصوى كالتنمية الاقتصادية مثلاً وليس بلد آخر هو فلسطين. ولكن من المهم التوضيح هنا بأن المركزية لا تعني بأي حال من الأحوال تخلي المواطن العربي عن قضاياه الوطنية كالمطالبة بحقوقه بالحرية والكرامة والتنمية الاقتصادية وتقديم الولاء عوضاً عن ذلك للقضية الفلسطينية. إن مركزية القضية الفلسطينية تستوجب في الحقيقة على المواطن العربي أن يكون حراً مزدهراً في وطنه لا ضعيفاً مقهوراً والا تحول عبئاً على القضية الفلسطينية لا داعماً لعدالتها، فكيف لمواطن فاقد للحرية وللكرامة الإنسانية في وطنه هو أن يمنحها لفلسطين.
فالمركزية بهذا الإطار إذاً تعني الالتزام العربي بحل عادل للقضية الفلسطينية وتوفير الدعم المطلوب بأشكاله المختلفة وذلك ضمن ما تسمح به أولوياتهم الوطنية دون أن يكون على حسابها. فحتى دولة مثل الجزائر التي يكاد لا يختلف فيها اثنان على مركزية القضية الفلسطينية فيها لا تعني المركزية هناك تقدمها على أولويات التنمية الشاملة والمستدامة والإصلاح السياسي والحكم الجيد والتداول السلمي للسلطة، بل على العكس تماماً فكما أسلفنا فإن نجاح الجزائر بتحقيق هذه الأولويات الوطنية يشكل التمثيل الحقيقي للقضية الفلسطينية ومركزيتها هناك.
وعليه، وللإجابة على التساؤل إن كانت القضية الفلسطينية ما زالت تمثل قضية العرب المركزية فإن ذلك يتطلب التفريق بين المستويين الرسمي والشعبي العربي. أولاً، مستوى النظام الرسمي العربي: يمكن رصد التغيرات التي أصابت بنية النظام الإقليمي العربي وموقفه من القضية الفلسطينية بالنظر الى أولاً مؤتمر الخرطوم عام 1967 والذي شكل حالة من الإجماع العربي على لاءاته الثلاث «لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات»، ولكن ما لبث هذا الصوت العربي الواحد أن يتحول إلى معسكرين عام 1978 على أثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد ليتشكل تجمع مضاد له متمثلاً بجبهة الصمود والتصدي التي قدمت نفسها بديلاً لـ«الرجعية العربية» آنذاك. هذا الانقسام تحول لاحقاً وتحديداً بعد اتفاق أوسلو الى محور الاعتدال العربي مقابل ما سمي بـ«محور المقاومة». ثم أخير يشهد النظام الإقليمي العربي تحولاً بنيوياً جديداً بحيث تنتقل إسرائيل لأول مرة من موقع العدو إلى موقع الحليف وضمن أجندة إقليمية متفق عليها تشترك فيها حتى الآن الإمارات والبحرين وربما السودان ودول أخرى. وهذا يعتبر خطوة متقدمة عن اتفاقات السلام المصرية والأردنية مع إسرائيل على اعتبار أن تلك الاتفاقيات مثلت «ساماً بارداً» محصور بين الأنظمة ومنفصلاً عن الشعوب وذات أجندات ثنائية بينما يتم الحديث في حالة السلام الإماراتي - الإسرائيلي عن «سلام دافئ» يقوم على الشعوب، وذات أجندات إقليمية مثل مواجهة إيران وتركيا والإسلام السياسي وغير ذلك.
يوضح هذا التغير البنيوي في النظام الإقليمي العربي وانتقال إسرائيل من موقع «العدو للجميع» إلى «الحليف للبعض» أن قضية فلسطين لم تعد تحظى بالمركزية التي تميزت بها لدى هذا الفريق تاريخياً حيث حل محلها قضايا مركزية إقليمية أخرى غيرها. كذلك فمن غير المحتمل أن تعاود فلسطين إلى موقع المركزية لدى هذه الأنظمة مرة أخرى كما كان يحدث في السابق عندما كان يتراجع موقع القضية على سلم الأولويات العربية الرسمية عندما تجتاحها أزمات كبيرة لتعاود إلى رأس سلم الأولويات مرة أخرى لاحقاً. إذا نظرنا إلى التغيير الذي أصاب بنية النظام العربي منذ مؤتمر الخرطوم وحتى الآن، فإن منحنى التغيير يشير إلى أن موقع القضية يمكن أن يتراجع أكثر لدى بعض الأنظمة.
إمكانية عودة فلسطين إلى المركزية على هذا المستوى هو مرهون بالتغيير الجذري أي التغيير في بنية الأنظمة السياسية لدى هذه الدول مثل حدوث انقلابات أو انهيار أنظمة حكم أو انتصار ثورات مضادة مثل ثورات العربي الذي هدد ديمومة العديد من الأنظمة الاستبدادية، واحتماليات حدوث مثل هذه التغييرات البنيوية والجذرية تبقى ضئيلة في الوقت الراهن إذ لا يتوفر من المؤشرات السياسية التي يوحي بذلك. أيضاً من الضروري التنبيه، أن التغيير دوماً يحمل الاتجاهين الإيجابي والسلبي أي أن التغيير الإيجابي لصالح القضية الفلسطينية لن يكون مضموناً وقد يأتي ما هو أسوأ من الوضع الراهن، إذ يبقى ذلك خياراً وارداً.
ثانياً، المستوى الشعبي: يصعب الحديث في الوضع الراهن عن تراجع جوهري وكبير للقضية الفلسطينية على هذا المستوى برغم كل ما يتم الترويج له في الإعلام الرسمي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من قبل كتاب الأنظمة والمدافعين عن سياساتها، فقد أظهر استطلاع مؤشر الرأي العربي الذي يجريه المركز العربي أن أكثر من 85% من المستطلعة آرائهم من العرب يرفضون تطبيع بلادهم للعلاقات مع إسرائيل وأن 80% من المستجيبين يرون أن السياسات الإسرائيلية تهدد أمن المنطقة. ويعود التمسك بمركزية القضية الفلسطينية على المستوى الشعبي لمجموعة من الأسباب أهمها ارتباط قضية فلسطين بعوامل مثل القومية والدين والهوية والثقافة العربية بشكل عام، وأيضاً قيم إنسانية كالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وغيرها. أي أن ارتباط الكثير من العرب بالقضية الفلسطينية لا يتعلق برضاه عن القيادة الفلسطينية أو حتى عن الشعب الفلسطيني من عدمه ولكن لأن فلسطين تمثل لهم «أرض إسلامية» و«أرض الإسراء» بالنسبة لأصحاب التوجه الأيدلوجي الديني، وهي «أرض عربية» ومكون أساسي للهوية والثقافة العربية لأصحاب التوجه القومي، وهي قضية «عدالة وكرامة إنسانية» لأصحاب التوجه الإنساني، وخليط ما بين هذه الأسباب وغيرها أو جزء منها لآخرين. ولأن القضية الفلسطينية مرتبطة بهم وبهويتهم وثقافتهم، فالتراجع عن الرؤية المركزية لها يبقى صعباً، فلن يضيرهم مثاً انقسام حركتي فتح وحماس أو أي من إخفاقات القيادة الفلسطينية الأخرى.
هذا ينقلنا الى سؤال آخر حول مدى أو درجة ارتباط الشعوب العربية بهويات دينية، قومية، ليبرالية، إنسانية وما إلى غير ذلك، والإجابة أن هناك تباين بدرجات الانتماء وتنوعها. فنجد هناك اتجاهات ذات انتماء وطني شوفيني ضيق كثيراً ما يعبر عنه بشعارات مثل «الدولة أولاً» حيث يكون الانتماء فيه إلى الدولة الوطنية أولاً ويتم تصويره على أنه يتناقض مع الانتماء القومي العربي الأوسع، بما فيها القضية الفلسطينية. أيضاً، هناك اتجاهات غير منتمية لشيء غير مصالحها الشخصية بغض النظر عن مكان وجودها، وهذه الفئة أيضاً يصعب شرح الجانب الهوياتي لها المرتبط بفلسطين الأرض والتاريخ. بالإضافة لذلك، فإن هناك اتجاه عربي ثالث قد ارتبطت هويته بظاهرة العولمة بجوانبها الاقتصادية والثقافية أكثر مما ارتبطت هويته بالتاريخ والإرث الثقافي والسياسي العربي. هذه الاتجاهات الثلاث – وربما آخرين – من الممكن جدا لها أن يتخلى جزء منهم عن القضية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال يهتم البعض منهم بالتسوق في محلات هارودز في لندن أهم له من التسوق في القدس العتيقة والصلاة في مسجدها الأقصى.
بناءاً على ما تقدم، فإن الفلسطينيين مطالبون بتبني استراتيجية جديدة لإدارة العلاقة مع العرب تأخذ بعن الاعتبار التغيرات التي طرأت على الموقفين الرسمي والشعبي إذ أن الجمود الفلسطيني والتعامل مع القيادات العربية باعتبارها جمال عبد الناصر والملك فيصل والشيخ زايد، سيلقي بهم خارج المعادلة الإقليمية. ويمكن تلخيص سمات هكذا استراتيجية بالنقاط التالية:
أولاً: ضرورة ابتعاد القيادة الرسمية والحزبية الفلسطينية عن الصدام مع الأنظمة المطبعة مهما تمادت في هجومها على الجانب الفلسطيني، حيث أن معادلة الصراع تقوم على أنه حتى ولو تفوقت القيادة الفلسطينية على الجانب العربي في صدام كلامي محتمل فإن النتيجة الفعلية تقضي بخسارة الفلسطينيين لأسباب كثيرة أقلها أن معركة الفلسطينيين هي ليست مع العرب ولكن مع المشروع الكولونيالي الإسرائيلي الجاثم على أرضهم.
ثانياً: الابتعاد عن وضع العرب في مفاضلة عليهم أن يختاروا فيها بين قضاياهم الوطنية والقضية الفلسطينية. من المهم أن يعي الفلسطينيين أن للعرب أيضاً تحديات وأجندات وطنية وهي بحاجة إلى معالجات من نوع معين ليس لها علاقة بالقضية الفلسطينية. الأولويات غير ثابتة وهي بتغير مستمر وما هو أولوية اليوم قد يصبح في آخر سلم الأولويات غداً. فعلى سبيل المثال كانت الأولوية القصوى للكويت في بداية التسعينيات تتمثل بالتحرير والخاص من الاحتلال الصدامي، ورغم أن الموقف الرسمي الفلسطيني خذل الكويت آنذاك إلا أن فلسطين هي على رأس سلم أولويات السياسة الخارجية الكويتية. هذا يقودنا للاستنتاج بأن على الفلسطينيين أن ينظروا بعيون استراتيجية للعلاقة مع العرب تحديدها بموقف محدد، وأن لا يستشيطوا غضباً إن تراجع موقع القضية الفلسطينية بعض الشيء اليوم.
ثالثاً: تأطير المشكلة مع الأنظمة العربية تأخذ أبعاداً إضافية لتلك التي تتحدث عن المواقف القومية والعروبية لتطال بشكل أساسي الموقف العربي من القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إذ أن هذه الرموز تأخذ بعداً هوياتياً يشترك فيه العرب والفلسطينيين. موافقة العرب على السيادة الرسمية الكاملة لإسرائيل على القدس يعتبر تنازلاً عن بعداً أساسياً بهويتهم العربية، وبالتالي فإن التمسك بالقدس هو من أجل القدس ومن أجل المحافظة على الهوية العربية، وليس من أجل «مساعدة الأشقاء الفلسطينيين». ليس سراً أن العقبة الكبرى التي تواجه إمكانية التسوية للصراع هي قضية القدس أولاً وأخيراً. ففي محادثات كامب ديفيد بين عرفات وباراك توصل الطرفان الى تفاهمات تقريباً حول كل تحديات الحل بما فيها قضية اللاجئين والاستيطان وغيرها، إلا أن الانهيار في المفاوضات جاء على أرضية الخلاف حول القدس، وفي مثل هكذا محادثات كان الفلسطينيون لا يمثلون أنفسهم فقط بل العالمين العربي والإسلامي.
تأطير المشكلة مع الأنظمة العربية على أنها ليست حول دعم العرب للشعب الفلسطيني من عدمه، ولكنها حول موقف العرب من القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وهذا هو جوهر الخلاف مع العرب، حن يبرر بعضهم التقارب مع إسرائيل بسبب «فشل القيادة الفلسطينية». نجاح أو فشل القيادة الفلسطينية هو موضوع آخر ليست له علاقة بموافقة بعض العرب على السيادة الرسمية الكاملة لإسرائيل على القدس، التي هي جزء من ثقافتهم العربية. وليس سرّاً أن العقبة الكبرى التي تواجه إمكانية التسوية للصراع هي قضية القدس أولاً وأخيراً. ففي محادثات كامب ديفيد بين عرفات وباراك، توصل الطرفان إلى تفاهمات تقريباً حول كل تحديات الحل، بما فيها قضيتا اللاجئين والاستيطان وغيرهما، إلا أن الانهيار في المفاوضات جاء على أرضية الخلاف حول القدس، وفي مثل هكذا محادثات، كان الفلسطينيون لا يمثلون أنفسهم فقط، بل العالمين العربي والإسلامي.
رابعاً: القيادة الفلسطينية بحاجة إلى تطوير خطاب جديد في تعاملها تحديداً مع الأنظمة العربية في دول الخليج العربي، والتي كحقيقة موضوعية غيرت جميع قياداتها التاريخية واستلمت قيادة شابة لم تعايش جيل الملك فيصل والشيخ زايد رحمهما الله. التنشئة السياسية للقيادة الخليجية الشابة تختلف كثيراً عن الأدلجة القومية التي مر بها جيل القيادة السابق. يمكن اعتبار التنشئة السياسية هذه بأقرب ما تكون إلى كونها وطنية ذات بعد دولي. بلا شك، فما زال البعد القومي يحتل حيزاً مهماً لدى بعض القيادات الشابة العربية، ولكن تواجد إلى جانبه اليوم قيم أخرى إنسانية مثل العدالة والحرية والكرامة الإنسانية يمكن للفلسطينيين أن يبنوا جسوراً مع العرب على أرضيتها. تبلور الهوية الإنسانية أصبح يشكل فضاء جديد للفلسطينيين لصياغة أطر عمل مشتركة مع العرب وغيرهم.
خامساً: الفلسطينيون أخذوا «شرعية القضية الفلسطينية» و«قدسيتها» كحقيقة تدافع عن نفسها بنفسها، وهذا فهم مغلوط لأثر العدالة على السياسة الدولية. هناك حاجة لانخراط فلسطيني مع الخليج العربي بمستوياته الرسمية وغيرها للدفاع عن عدالة القضية وقدسيتها وتشابكها، ليس فقط مع المصلحة الخليجية، ولكن مع هويتها أيضاً.
سادساً: بدون شك فإن الإحباط الفلسطيني من التطبيع العربي له ما يبرره، ولكن بنهاية المطاف فإن هناك مستجدات في السياسة الدولية يجب التعامل معها. التطبيع العربي مع إسرائيل سيخلق مجالات جديدة بالإمكان استغلالها لممارسة ضغوط على إسرائيل وعلى الجانب الفلسطيني الاهتمام بها لتفعيل الضغط على إسرائيل بأشكاله الجديدة. بدون شك فإن سلاح المقاطعة يبقى الأكثر فاعلية ضد النظام الكولونيالي الإسرائيلي في فلسطين خصوصاً في مرحلة بدأ هذا السلاح يتعاظم في مناطق كثيرة من العالم. ولكن وبما أن التطبيع الخليجي قد حدث فا بد من أقلمة أشكال الضغط لتتناسب والمرحلة الجديدة والمهم أن لا تترك إسرائيل تستأثر بالخليج في المرحلة الجديدة. أخيراً، يجب علي القيادة الفلسطينية أن تتعامل مع توقف الدعم العربي كحقيقة واقعة يوماً ما عاجاً أم آجلاً وتبدأ بتطوير استراتيجيات للاعتماد على ذاتها، لا تنتظر حتى تقع «الفأس بالرأس» ولتأخذ العبرة من عدوها حيث قامت إسرائيل وبرغم الرعاية الغربية غير المحدودة لمشروعها الكولونيالي في فلسطين بتطوير قدراتها الذاتية وسعت لامتاك قدرات نووية منذ الستينيات حتى لا يكون مشروعها الصهيوني في فلسطين عرضة للتغيرات في نتائج العملية الانتخابية في واشنطن ولندن. من الخطأ القاتل تعاطي القيادة الفلسطينية مع الدعم العربي سواء في الخليج أو غيره على أنه حقيقة ثابتة. لقد سعت القيادة الفلسطينية تاريخياً على أن يكون القرار الوطني الفلسطيني مستقل، وهذا جيد، ولكن يأتي مع الاستقلالية مسؤولية كبيرة وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية، وذلك بتطوير قدراتها الذاتية حتى لا يصبح المشروع الوطني عرضة لتغيرات رؤى وقيادات عواصم عربية مختلفة.